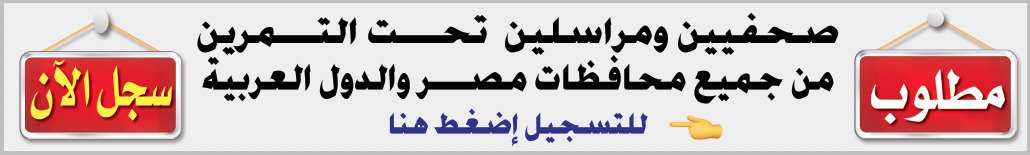تعيش المنطقة لحظة فارقة تتقاطع فيها خطوط النار والمصالح من البحر الأحمر إلى شرق المتوسط. ومع تصاعد التوترات – من الغارات الإسرائيلية على الدوحة إلى هجمات الحوثيين التي أربكت الملاحة العالمية – تعود فكرة الدفاع الخليجي المشترك إلى صدارة المشهد، ليس بوصفها نصًّا قديمًا في أرشيف القمم، بل كخيار استراتيجي تفرضه حقائق الميدان. وفي الأفق يطلّ سؤال أكبر: هل تقود هذه التطورات إلى تحالف أوسع يضم مصر وتركيا وإيران وباكستان؟
من نصوص على الورق إلى درع ميداني
اتفاقية الدفاع المشترك التي وقّعتها دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة عام 2000 نصّت بوضوح على أن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع. وقد شُكِّلت قوات درع الجزيرة لتكون الذراع العسكرية لهذا المبدأ. لكن التحولات الأخيرة – من الهجمات الحوثية إلى الضربات الإسرائيلية – أيقظت هذه الاتفاقية من سباتها.
اجتماع استثنائي لوزراء الدفاع الخليجيين في الدوحة كان نقطة التحول: شبكة تبادل استخباراتي لحظي، نقل حي لصورة الموقف الجوي، تسريع منظومة إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتدريبات عملياتية مشتركة خلال ثلاثة أشهر. فجأة تحوّل “النص” إلى خطة تحرك على الأرض، والخليج إلى لاعب يرسم قواعد الردع بيده.
اليمن… جبهة النار الممتدة إلى إسرائيل
الحوثيون، الذراع الأكثر نفوذاً لإيران، كثّفوا هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ نحو أهداف إسرائيلية، وهدّدوا شرايين الملاحة في البحر الأحمر التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. وردّت إسرائيل بضربات مركّزة على صنعاء والحديدة، ما جعل البحر الأحمر برميل بارود يهدّد صادرات الطاقة وأمن الممرات البحرية. وهنا يكتسب الدفاع الخليجي المشترك بعداً يتجاوز الدفاع عن حدود الدول الأعضاء، ليصبح ركيزة لحماية التجارة العالمية وعمود استقرار أسواق الطاقة.
بين واشنطن والاعتماد على الذات
هذا التحرك الخليجي لا يعني التخلي عن القواعد الأميركية المنتشرة في قطر والبحرين والكويت والسعودية والإمارات. فهذه القواعد ما زالت حجر زاوية في ميزان الردع الإقليمي، وتوفر منظومات إنذار مبكر وقدرات لوجستية يصعب الاستغناء عنها سريعاً. لكن التفعيل الجاد للاتفاقية يعزز استقلال القرار الأمني ويرسل إشارة واضحة إلى واشنطن: الخليج يوسّع خياراته الدفاعية.
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو إعادة تعريف الدور الأميركي: من وجود قتالي دائم إلى شراكة تدريبية ودعم استخباراتي، فيما تنوّع دول الخليج شراكاتها نحو قوى آسيوية وأوروبية في مجالات الدفاع الصاروخي والأمن السيبراني. إنها ليست قطيعة مع واشنطن، بل توازن جديد يرفع سقف الاستقلالية.
نحو تحالف إسلامي أوسع؟
وسط هذه التغيرات، يبرز سؤال: هل يمكن أن يفتح هذا المشهد الباب لتحالف إسلامي أوسع يضم مصر وتركيا وإيران وباكستان؟ من الناحية النظرية، هناك دوافع قوية:
تهديدات مشتركة من الإرهاب إلى اضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
رغبة متزايدة في تقليل الاعتماد على القوى الغربية.
روابط تاريخية داخل منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ومجموعة الدول النامية الثماني (D-8).
غير أن الطريق مليء بالعقبات: تباينات حادة في المواقف من سوريا وفلسطين، تناقضات في تحالفات كل دولة مع الغرب، وانعدام ثقة تاريخي بين بعض العواصم. كما أن أي تحالف عسكري صريح قد يستفز الولايات المتحدة وأوروبا ويجرّ عقوبات أو توتراً اقتصادياً.
السيناريو الأقرب هو تعاون سياسي وأمني محدود: تنسيق دبلوماسي في المنظمات الدولية، تبادل معلومات استخباراتية، وربما تدريبات أو اتفاقيات جزئية لحماية الممرات البحرية. أما تحالف عسكري شامل على غرار “ناتو إسلامي” فيبقى احتمالاً بعيد المدى، ما لم تفرضه أزمات كبرى أو مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.
لحظة إعادة رسم خرائط القوة
ما يجري اليوم هو إعادة تعريف لدور الخليج في معادلة الشرق الأوسط: من ساحة عبور للتوترات إلى مركز قرار يصوغ موازين الردع. ومن خلف هذه المعادلة تلوح احتمالات اصطفافات جديدة قد تشمل قوى إسلامية كبرى إذا توافرت الظروف. وبين صواريخ الحوثيين وغارات إسرائيل وحسابات واشنطن وطهران وأنقرة، يكتب الشرق الأوسط فصلًا جديدًا؛ فصلًا يختبر فيه الجميع قدرتهم على التحوّل من رد الفعل إلى صناعة المستقبل.
الخلاصة: الدفاع الخليجي المشترك لم يعد نصًا تاريخيًا، بل خيارًا إستراتيجيًا حيًا. وهو، في الوقت نفسه، مقدّمة محتملة لاصطفافات أوسع، حيث يظل حلم التحالف الإسلامي الكبير معلقًا بين ضرورات الأمن وحقائق السياسة، في منطقة تعرف جيدًا أن موازين القوة تُصنع دائمًا وسط العواصف.